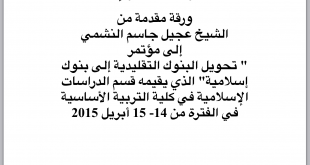تعريفه لغـة: الاستحسان مشتق من الحسن، وهو عد الشئ حسناً والحسن ضد القبح ونقيضه، ويقال الاستحسان الاستقباح فالمعنى طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به.()
تعريفه اصطلاحاً وبيان حقيقته: اختلفت ألفاظ الأصوليين في تعريف الاستحسان وبيان حقيقته وإن تقاربت المعاني، فعرفه الحنفية، وهم رأس القائلين به بتعاريف أشهرها أنه: العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه، أو هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول.
ولعل أصح تعريف له عندهم أنه: دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق إليه الأفهام، قال السعد التفتزاني: هذا تفسير الاستحسان، وبعض الناس تحيروا في تعريفه، وتعريفه الصحيح هو هذا. وتعريف المالكية يطابق ما عرفه به الحنفية: بأنه أقوى الدليلين. قال ابن العربي: والاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين، وشرح ابن فرحون هذا المعنى بقوله: بأن تكون الحادثة مترددة بين أصليـن
وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد إلا مع القياس البعيد الظاهري، أو عرف جار، أو ضرب من المصلحة، أو خوف مفسدة، أو ضرب من الضرر والعذر، فيعدل عن القياس على الأصل القريب إلى القياس على ذلك الأصل البعيد، وهذا من جنس وجوه الاعتبار، وأتم طريقة للقائسين. وزاد ذلك وضوحاً في منح الجليل بقوله: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أغلب من القياس هو أن يكون طرد القياس يؤدي إلى غلو في الحكم، ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم، فيختص به ذلك الموضع، والحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام، ومن الاستحسان مراعاة الخلاف وهو أصل في المذهب.
الألفاظ ذات الصلة:
الاستحسان والقياس الجلي و الخفي:
العلاقة وثيقة ومتداخلة بين القياس والاستحسان. فالقياس يطلق على معنى أعم وهو مساواة فرع الأصل في علة حكمه، كما هو تعريف ابن الحاجب، ويقسم باعتبار اشتماله على المؤثر إلى جلي وخفي باعتبار ظهور ذلك المعنى وخفائه، وقد يطلق على معنى أخص من ذلك وهو قسم منه وهو القياس الجلي المذكور في مقابلة الاستحسان في المسائل التي فيها قياس واستحسان، فلفظ القياس على هذا مشترك بين مفهوم الأعم ومفهوم الأخص، وهو الجلي منه، وكذا الاستحسان يطلق على معنى أعم من القياس، وهو ترك القياس الجلي بدليل أقوى، وهو بهذا الإعتبار أربعة أقسام. ويطلق على معنى أخص منه وهو قسم منه، وهو القياس الخفي. فقد ظهر من هذا أن بين القياس بالمعنى الأعم، وبين الاستحسان بالمعنى الأخص عموماً وخصوصاً من وجه، لوجود القياس بدون الاستحسان في صورة القياس الجلي في مقابلة الخفي، ووجود الاستحسان بدون القياس في صورة الاستحسان بالأثر والإجماع أو الضرورة. ووجودهما معاً في القياس الخفي في مقابلة الجلي.
وبين القياس الجلي والاستحسان الخفي مباينه، وبين الاستحسان بالمعنى الأعم، وبينه بالمعنى الأخص عموم وخصوص مطلق، وكذا بين القياس بالمعنى الأعم والأخص، والمراد هنا هو القياس بالمعنى الأعم لأنه هو المنقسم إلى القياس والاستحسان بمعناهما، والمراد بالقياس والاستحسان اللذين هما قسمان له هو القياس الجلي الذي يقابله القياس الخفي، والاستحسان الذي هو بمعنى القياس الخفي الذي هو في مقابلة القياس الجلي.
وأما العلاقة بين الاستحسان والقياس الخفي، فإن القياس الخفي استحسان، ولكن الاستحسان أعم منه، فإن كل قياس خفي استحسان، وليس كل استحسان قياساً خفياً، لأن الاستحسان قد يطلق على غير القياس الخفي.
وإذا أطلق الحنفية الاستحسان أرادوا به القياس الخفي، وإذا أطلقوا القياس أرادوا به القياس الجلي، فالاستحسان عندهم هو أحد القياسين لا أنه يكون قسماً آخر اخترعوه بالتشهي من غير دليل. فاستعملوا عبارة القياس والاستحسان للتمييز بين الدليلين المتعارضين، وخصوا أحدهما بالاستحسان لكون العمل به مستحسناً ولكونه مائلاً عن سنن القياس الظاهر، فسموه بهذا الإسم لوجود معنى الاسم فيه.()
الاستحسان والمصلحة والمصلحة المرسلة:
يلتقي الاستحسان عند التحقيق مع عموم المصلحة، إذ هو من الاستدلال بالمصلحة التي هي جلب منفعة أو دفع مفسدة مقصودة للشارع لا مطلق منفعة أو مفسدة ، والاستحسان مصلحة جزئية لها مستند من الشرع سواء من أثر أو إجماع أو عرف ونحو ذلك – مما سيأتي تفصيله – لا مطلق استحسان ولذا عرف الشاطبي الاستحسان بأنه: مصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي.
كما يلتقي الاستحسان مع المصلحة المرسلة التي شهد الشرع لجنسها وليست مصلحة غريبة، والاستحسان استدلال بمصلحة مرسلة في مقابل قياس أو عموم، والقياس ذاته مبناه تحقيق مصلحة شهد الشرع لنوعها.
تقسيم القياس والاستحسان:
ينقسم القياس والاستحسان من حيث القوة والضعف والصحة والفساد، فكل منهما على وجهين: أما أحد نوعي القياس فما ضعف أثره، والنوع الثاني ما ظهر فساده، واستترت صحته وأثره، وأحد نوعي الاستحسان ما قوي أثره وإن كان خفياً، والثاني ما ظهر أثره وخفى فساده، وإنما الاستحسان أحد القياسين لكنه يسمى به إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به. وإنما تنوع كل من القياس والاستحسان باعتبار الأثر لأن الأثر قد يكون قوياً وغير قوي، فصار كل واحد على وجهين باعتبار ضعف الأثر، وقوته. وهذا ليس تقسيماً لنفس القياس والاستحسان باعتبار ذاتهما، فإن القياس الخالي عن معارضة الاستحسان خارج عن هذا التقسيم، وكذلك الاستحسان الثابت بالنص والإجماع والضرورة خارج عنه أيضاً، فكان معناه أن كل واحد منهما في مقابلة الآخر على وجهين، فما ضعف أثره أي بالنسبة إلى قوة أثر مقابله وهو الاستحسان. والثاني ما ظهر فساده أي ضعفه، لأنه إذا ضعف بمقابلة الآخر فسد. فالمراد بالضعف والفساد ههنا واحد.()
وأما من حيث الترجيح بينهما عند التعارض. فلا يرجح الاستحسان إلا في صورة واحدة وهي أن يكون القياس ضعيف الأثر، والاستحسان قوي الأثر، أما إذا كان القياس قوي الأثر والاستحسان ضعيف الأثر فواضح، وأما إذا كانا قويين فالقياس
يرجح لظهوره. وأما إذا كانا ضعيفين فإما أن يُسقط أن يعمل بالقياس لظهوره فالحكم المتيقن هو أن الاستحسان لا يرجح على القياس في هذه الصور الثلاث، ويرجح في صورة واحدة هي المذكورة قبل.
وأما الترجيح بين صحيح الظاهر والباطن وفاسدهما، وصحيح الظاهر فاسد الباطن، والعكس أي صحيح الباطن فاسد الظاهر، فإن الأول من القياس يرجح على كل استحسان، وأما فاسدهما فمردود. وبقى الأخيران، فالأول من الاستحسان أي صحيح الظاهر والباطن يرجح على قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن. وعلى عكسه أي فاسد الظاهر صحيح الباطن، وأما الاستحسان فاسد الظاهر والباطن فمردود، وبقى الأخيران من الاستحسان، وهما صحيح الظاهر فاسد الباطن، وعكسه أي فاسد الظاهر صحيح الباطن، فالتعارض بينهما وبين أخيري القياس إن وقع مع خلاف النوع، فما ظهر فساده بادئ النظر لكن إذا تؤمل تبين صحته أقوى مما كان على العكس. وعلى هذا فالتعارض بين كل واحد من هذين القسمين من الاستحسان أي صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه، وبين كل واحد من أخيري القياس إن وقع مع اختلاف النوع وهذا في صورتين: إحداهما أن يعارض صحيح الظاهر فاسد الباطن من الاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن من القياس. وثانيهما أن يعارض فاسد الظاهر صحيح الباطن من الاستحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن من القياس فلا شك أن ماظهر فساده بادئ النظر لكن إذا تبين صحته أقوى مما كان على العكس سواء كان قياساً أو استحساناً.
وبيان الاستحسان الذي يظهر أثره ويخفي فساده مع القياس الذي يستتر أثره ويكون قوياً في نفسه حتى يؤخذ فيه بالقياس ويترك الاستحسان مثاله ما قال السرخسي: إذا قرأ المصلي سورة في آخرها سجدة فركع بها في القياس تجزيه، وفي الاستحسان لا تجزيه عن السجود، وبالقياس نأخذ، فوجه الاستحسان أن الركوع غير السجود وضعاً، ألا ترى أن الركوع في الصلاة لا ينوب عن سجود الصلاة فلا ينوب عن سجدة التلاوة بطريق الأولى، لأن القرب بين ركوع الصلاة وسجودها أظهر من حيث إن كل واحد منهما موجب التحريمة، ولو تلا خارج الصلاة فركع لها لم يجز عن السجدة ففي الصلاة أولى، لأن الركوع والسجود يتشابهان، قال تعالى: ” وخر راكعا وأناب ” أي ساجداً، ولكن هذا من حيث الظاهر مجاز محض، ووجه الاستحسان من حيث الظاهر اعتبار شبه صحيح، ولكن قوة الأثر للقياس مستتر، ووجه الفساد في الاستحسان خفي، وبيان ذلك أنه ليس المقصود من السجدة عند التلاوة عين السجدة، ولهذا لا تكون السجدة الواحدة قربة مقصودة بنفسها حتى لا تلزم بالنذر، إنما المقصود إظهار التواضع وإظهار المخالفة للذين امتنعوا من السجود استكباراً منهم كما أخبر الله عنهم في مواضع السجدة. ومعنى التواضع يحصل بالركوع ولكن شرطه أن يكون بطريق هو عبادة، وهذا يوجد في الصلاة، لأن الركوع فيها عبادة كالسجود ولا يوجد خارج الصلاة، ولقوة الأثر من هذا الوجه أخذنا بالقياس وإن كان مستتراً وسقط اعتبار الجانب الآخر في مقابلته. ومثاله أيضاً في البيوع إذا وقع الاختلاف بين المسلم إليه ورب السلم في ذرعان المسلم فيه في القياس يتحالفان، وبالقياس نأخذ، وفي الاستحسان القول قول المسلم إليه، ووجه الاستحسان أن المسلم فيه مبيع فالاختلاف في ذرعانه لا يكون اختلافاً في أصله بل في صفته من حيث الطول والسعة وذلك لا يوجب التحالف، كالاختلاف في ذرعان الثوب المبيع بعينه، ووجه القياس أنهما اختلفا في المستحق بعقد السلم وذلك يوجب التحالف، ثم أثر القياس مستتر ولكنه قوي من حيث إن عقد السلم إنما يعقد بالأوصاف المذكورة لا بالإشارة إلى العين، فكان الموصوف بأنه خمس في سبع غير الموصوف بأنه أربع في ستة، فبهذا يتبين أن الاختلاف هنا في أصل المستحق بالعقد فأخذنا بالقياس لهذا.
ومن هذا يظهر أن المتفق عليه أنه لا تعارض بين قياسين صحيحين في الواقع، ولابين قياس قوي الأثر واستحسان كذلك كما لا يقع بين قياس صحيح الظاهر والباطن، وبين استحسان كذلك، وكذا لا يقع بين قياس فاسد الظاهر صحيح الباطن وبين استحسان كذلك.
وينبغي التنبيه على أن الاستحسان إذا عارضه القياس، وعمل بالاستحسان في الحالات التي يقدم فيها على القياس، فلا يجوز العمل بالقياس، وقد توهم بعض عبارات الحنفية ذلك. قال السرخسي: إن بعض المتأخرين من أصحابنا ظن أن العمل بالاستحسان أولى مع جواز العمل بالقياس في موضع الاستحسان، وهذا وهم عندي فإن اللفظ المذكور في عامة الكتب: إلا أنا تركنا هذا القياس، والمتروك لا يجوز العمل به. فالصحيح ترك القياس أصلاً في الموضع الذي نأخذ بالاستحسان، وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة، ولكن باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى أصلاً.
أدلة القائلين بالاستحسان:
استدل القائلون بالاستحسان وهم الجمهور بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فاستدلوا بجواز إطلاق لفظ الاستحسان بقوله تعالى: ” فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب “.()
وقال تعالى: ” واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم “.()
فقد ندب الله تعالى إلى فعل الحسن، وأوجب الهداية لفاعله وقد جاءت الآيات في معرض المدح والثناء بإتباع الأحسن، وقال صلوات الله وسلامه عليه: في الحديث الموقوف على ابن مسعود: ” ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ” () فلولا أنه حجة لما كان عند الله حسناً.
وأما الإجماع: فإن الأمة مجمعة على استحسان دخول الحمام وشرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير لزمان السكون وتقدير الماء والأجرة.
وقال الجصاص: تكلم قوم من مخالفينا في إبطال الاستحسان حين ظنوا أن الاستحسان حكم مما يشتهيه الإنسان ويهواه، أو يلذه، ولم يعرفوا معنى قولنا في إطلاق لفظ الاستحسان فتعسفوا القول فيه من غير دراية وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان فإنهم إنما قالوه مقرونا بدلائله وحججه لا على جهة الشهوة واتباع الهوى.()
أدلة النافين للاستحسان:
استدل الشافعي على إبطال الاستحسان بأدلة من القرآن الكريم فاستدل بقوله تعالى: ” أيحسب الإنسان أن يترك سدى ” () فلم يختلف أهل العمل بالقرآن أن السدى الذي لا يؤمر ولا يُنهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى، وقد أعلمه الله أنه لم يتركه سدى. وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ” اتبع ما أوحي إليك من ربك “() وقال: ” وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم “() ثم جاءه قوم فسألوه عن أصحاب الكهف وغيرهم، فقال: أعلمكم غداً يعني، أسأل جبريل ثم أعلمكم، فأنزل الله عز وجل: ” ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله “.()
وجاءته امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوساً، فلم يجبها حتى أنزل الله عزو وجل: ” قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها “() وجاءه العجلاني يقذف امرأته، قال لم ينزل فيكما، وانتظر الوحي، فلما نزل دعاهما فلاعن بينهما، كما أمره الله عز وجل، وقال لنبيه: ” وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ” () وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق، ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نصاً أو دلالة من الله، فقد جعل الله الحق في كتابه، ثم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس ينزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصاً أو جملة.()
أنواع الاستحسان:
تتعدد أنواع الاستحسان من حيث مستنده ودليله إلى استحسان بالأثر، والإجماع، والضرورة والحاجة، والقياس الخفي، والعرف، والمصلحة.
أولاً – الاستحسان بالأثر: مثل السلم، فإن القياس يأبى جوازه لعدم المعقود عليه الذي هو محل العقد، إلا أنهم تركوا القياس بالأثر الموجب للترخيص، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم فقال: ” من أسـلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم “، ومثله خيار الشرط جاز استحسانا لورود النص في السنة بجواز الخيار إلى ثلاثة أيام استثناء من الأصل الكلي في العقود بلزومها.
ثانيا ً- الاستحسان بالإجماع: مثل الاستصناع، فالاستصناع فيما فيه تعامل الناس مثل أن يأمر إنساناً أن يخرز له خُفاً بكذا، ويبين صفته ومقداره، ولم يذكر له أجلاً فالقياس يقتضي أن لا يجوز، لأنه بيع معدوم، لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه.
ثالثاً – الاستحسان بالضرورة والحاجة: مثل تطهير الأواني، فإن القياس يقتضي عدم تطهيرها إذا تنجست، لأنه لا يمكن صب الماء عليها حتى تطهر، وتركوا العمل بالقياس لضرورة عامة الناس، ومثل تطهير الأواني تطهير الحياض والآبار، فإن القياس يأبى طهارتها بعد تنجسها، لأنه لا يمكن صب الماء على الحوض والبئر ليتأتى التطهير، ولأن الدلو والماء الطاهرين يتنجسان بملاقاة ماء البئر والآنية المتنجسين، ولأن مقارنة النجس باقياً على نجاسته لا يفيد طهارة لكنهم تركوا العمل بموجب هذا القياس للضرورة فإن لها أثراً في سقوط الخطاب، لأن فيه حرجاً، والحرج مدفوع بالنص ومثاله أيضاً: العفو عن رشاش البول، والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان التحرز منه. وكذلك عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس. فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق لأنها لا تبقى زمانين فلابد من إقامة العين المنتفع بها مقام المنفعة في حكم جواز العقد لحاجة الناس إلى ذلك.
رابعاً – الاستحسان بالقياس الخفي: مثل طهارة سؤر سباع الطير، فإن القياس الظاهر يقتضي نجاسته، لأن لحمه حرام كسؤر سباع البهائم، فلحمه حرام، والسؤر معتبر باللحم فيكون نجساً كسؤر سباع البهائم بجامع السؤر، وهذا المعنى ظاهر الأثر لأنهما استويا في نجاسة اللحم، لكنهم استحسنوا أن يكون طاهراً مكروهاً لأنها تشرب بمنقارها على سبيل الأخذ والابتلاع من غير مخالطة لعاب وهو عظم جاف طاهر لا رطوبة فيه فلا يتنجس الماء بملاقاته فيكون سؤرها كسؤر الآدمي ومأكول اللحم لانعدام العلة الموجبة للنجاسة وهي الرطوبة النجسة الحاصلة في آلة الشرب، كما في سباع البهائم فإنها تشرب بلسانها وهو رطب بلعابها المتولد من لحمها النجس، وما كان متولداً من تناول الميتات والنجاسات بمنقارها فيتوهم بقاء شئ من ذلك عليها.
خامساً – الاستحسان بالمصلحة: مثل تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منها، مع أن الأصل العام يقضي بعدم تضمين الأجير إلا بالتعدي أو التقصير لأنه أمين، ولكن كثيراً من الفقهاء يوجبون تضمينه استحساناً رعاية لمصلحة الناس وحفاظاً على أموالهم نظراً لخراب الذمم، وشيوع الخيانة. وقد عبر بعض المالكية عن الاستحسان بأنه استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي، مثاله: لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثة، فقيل يرد، وقيل يختار الإمضاء، قال أشهب القياس الفسخ، ولكنا نستحسن إن أراد الإمضاء أن يأخذ من لم يمض إذا امتنع البائع من قبوله نصيب الراد.
سادساً – الاستحسان بالعرف والعادة: مثل دخول الحمام من غير تعيين زمن المكث، وقدر الماء والأجرة، فإنه معتاد على خلاف الدليل العام لما فيه من الغرر، وكذا شرب الماء من السِّقاءِ من غير تعيين قدره، فقد جاز ذلك للعادة والعرف.
الفرق بين الاستحسان الثابت بالقياس الخفي وبقية الأنواع:
يختلف الاستحسان الثابت بالقياس الخفي عن الحكم الثابت بالأثر أو الاجماع أو الضرورة أو المصلحة أو العرف والعادة، بأن هذه الأنواع لا تقبل التعدية، لأنه معدول بها عن سنن القياس، فنرى مثلاً أن الاختلاف في مقدار الثمن من المتبايعين قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياساً جلياً عن سائر التصرفات، لأن المنكر هو المشتري لأنه لا يدعي شيئاً حتى يكون البائع أيضاً منكراً، فتكون اليمين عليه وحده، ويوجب الاختلاف يمين البائع أيضاً استحسانا بالقياس الخفي، وهو أن البائع ينكر وجوب تسليمه المبيع بما أقر به المشتري من الثمن، كما أن المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فتوجه اليمين على كل منهما، كما في سائر التصرفات، فإن اليمين تكون على المنكر، ووجوب التحالف قبل القبض حكم تعدى إلى وارثي البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن بعد موت البائع والمشتري، لأن الوارث يقوم مقام المورث في حقوق العقد. ()
تخصيص الحكم مع وجود العلة:
ويعبر عنه أيضاً بتخصيص العلة، وتخصيص العلة عبارة عن تخلف الحكم في بعض الصور عن الوصف المدعي علة لمانع، وإنما سمي تخصيصاً لأن العلة وإن كانت معنى، ولا عموم للمعنى حقيقة لأنه في ذاته شئ واحد، ولكنه باعتبار حلوله في محال متعددة يوصف بالعموم فإخراج بعض المحال التي توجد فيها العلة عن تأثير العلة فيه، وقصر عمل العلة على الباقي يكون بمنزلة التخصيص، كما أن إخراج بعض أفراد العام عن تناول لفظ العام إياه وقصره على الباقي تخصيص.
وقد اختلفوا في تخصيص العلة، فقال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي والشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص وأكثر الحنفية العراقيين أن تخصيص العلة المستنبطة جائز، وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل وعامة المعتزلة.
والخلاف في العلة المستنبطة ، فأما في العلة المنصوصة فاتفق القائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز فيها، ومن لم يجوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة، وبعضهم منعه في المنصوصة أيضاً، وهو مختار عبد القاهر البغدادي وأبي إسحاق الإسفرايني، وممن منعه في المستنبطة أبو الحسين البصري، والإمام فخر الدين الرازي، وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي، وهو منسوب إلى الشافعي.
وقد استوفى الإسنوي المذاهب في شرحه على منهاج البيضاوي عند الكلام على النقض هل هو قادح أن مبطل للعلية.
فالمذهب الأول: أن النقض لا يقدح في العلية مطلقاً، سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان التخلف لمانع أو لغير مانع، وهذا مذهب الحنفية، ويسمونه تخصيص العلة.
والمذهب الثاني: أنه يقدح مطلقاً وهو مذهب الشافعي ومختار الإمام فخر الدين الرازي.
المذهب الثالث: أنه يقدح في العلل المستنبطة، ولا يقدح في العلل المنصوصة، وهو المختار عند أكثر الشافعية، ولا فرق في الموضعين بين أن يكون التخلف لمانع أو لغير مانع.
المذهب الرابع: يقدح إذا كان لغير مانع، ولا يقدح إذا كان التخلف لمانـع، ولا فـرق في ذلك بين العلل المنصوصة والعلل المستنبطة. وهو المختار عند البيضاوي. وقد ذكر الشوكاني في النقض خمسة عشر مذهباً.()
الاستحسان وتخصيص الحكم مع وجود العلة:
قال الجصاص: إن ترك القياس إلى ماهو أولى منه على وجهين:
أحدهما: أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر، لدلالة توجبه، فسموا ذلك استحساناً.
والثاني: تخصيص الحكم مع وجود العلة.
والمراد بالاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة أنه متى وجب حكم لمعنى من المعاني قد قامت الدلالة على كونه علما للحكم، وسميناه علة له، فإن إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيثما وجد، إلا موضعاً تقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل فيه مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره، فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا. وقد يترك حكم العلة تارة بالنص، وتارة بالإجماع، وتارة بقياس آخر يوجب في الحادثة حكماً سواه، وإلحاقها بأصل غيره.
ونظير تركه بالنص: ما قاله الحنفية في الصغير يموت عن أمرأته وهي حامل أن القياس أن تكون عدتها أربعة أشهر وعشرا، لأن الحمل من غير الزوج، إلا أنه ترك القياس واستحسن أن يجعل عدتها وضع الحمل، لقوله تعالى: ” وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن “.() فسمى ترك القياس للعموم استحساناً. ومما خصوه من جملة القياس بالنص وتركوا فيه حكم العلة: قول الحنفية في الأكل ناسياً في رمضان. أن القياس أنه يقضي، إلا أنهم تركوا القياس فيه للنص.
وأما تخصيص العلة بالإجماع: فمن نظائره ما قامت الدلالة عليه من أن ملاقاة النجاسة للماء توجب الحكم بنجاسته، فلو التزم القياس وأجرينا الحكم على العلة، لأوجب ذلك أن لا يطهر الثوب الذي تصيبه النجاسة أو البدن أو الأواني أبداً، من قبل أن الماء الأول يلاقي نجساً فيتنجس، كذلك الماء الثاني يلاقي نجساً وهكذا إلا أنهم تركوا القياس وحكموا بطهارته إذا زال عين النجاسة لإجماع الأمة على طهارته إذا صار بهذا الحد، فهذا وجه مما ترك القياس فيه، وحكم موجب العلة بالإجماع.
وأما تخصيص العلة بالقياس: فنحو قول أبي حنيفة في رجل اشترى عبداً على أن يعتقه: أن الشراء فاسد إن أعتقه، فإن القياس أن يلزمه القيمة، لوقوع البيع على فساد.ومتى أعتق المشتري العبد المشترى شراء فاسداً بعد القبض، كان عليه قيمته، إلا أنه ترك هذا القياس، وقاس المسألة على أصل آخر ثابت عندهم جميعاً وهو العتق على مال. فلو أن رجلاً قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم، فأعتقه لزمه الألف، وعتق العبد عن المعتق عنه.
ولم يعد السرخسي وغيره هذه الأمثلة من تخصيص العلة، وإنما هي من باب انعدام الحكم لانعدام العلة، وذلك لا يكون من تخصيص العلة في شئ. قال سعد الدين
التفتزاني: الاستحسان ليس من تخصيص العلة على ما توهمه البعض من أن القياس ثابت في صورة الاستحسان، وفي سائر الصور، وقد ترك العمل به في صورة الاستحسان لمانع وعمل به في غيرها لعدم المانع فيكون باطلاً ” وإنما قلنا إنه ليس من تخصيص العلة، لأن انعدام الحكم في صورة الاستحسان إنما هو لانعدام العلة، فانتفى الحكم لذلك، وهذا معنى ترك القياس الجلي الضعيف الأثر بدليل قوي هو قياس خفي قوي الأثر، فلا يكون من تخصيص العلة في شئ.()
حقيقة الخلاف في القول بالاستحسان:
لم يختلف الفقهاء في الجملة في اعتبار الاستحسان دليلاً، وقد بنوا كثيراً من الفروع عليه، إلا أنهم يختلفون في تطبيقاته قلة وكثرة. فالمالكية أكثروا من القول بالاستحسان وإن كانوا أقل في ذلك من الحنفية، قال أصبغ بن الفرج: سمعت ابن القاسم يقول قال مالك: تسعة أعشار العلم الاستحسان، قال أصبغ: الاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس، وجوَّز مالك استئجار الأجير بطعامه وإن لم ينضبط مقدار الأكل ليسارة أمره، وقال ابن الأنباري: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان، وحاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس، ومثاله: لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات، وله ورثة، فقيل يرد، وقيل يختار الإمضاء، قال أشهب : القياس الفسخ، ولكنا نستحسن إن أراد الإمضاء أن يأخذ من لم يمض إذا امتنع البائع من قبوله نصيب الراد. وقال ابن العربي: علماؤنا من المالكية كثيراً ما يقولون: القياس كذا في مسألة، والاستحسان كـذا.
وقد قال الحنابلة بالاستحسان في مسائل، والتحقيق أن الإمام أحمد قال به. قال ابن تيمية، قال شيخنا: وقد أطلق أحمد القول بالاستحسان في مواضع قال في رواية الميموني: استحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء يصلي به حتى يحدث، أو يجد الماء، وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضاً فزرعها، الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وهذا شئ لا يوافق القياس، ولكن استحسن أن يدفع إليه نفقته، وقال في رواية المروذي يجوز شراء أرض السواد، ولا يجوز بيعها فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك، فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان ولذلك يمنع من بيع المصحف، ويؤمر بشرائه استحساناً، وقال في رواية صالح في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال، فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله.
والشافعية قالوا في بعض المسائل بالاستسحان، والتحقيق أن الإمام الشافعي نفسه قال في بعض المسائل منها قوله: حسن أن يضع المؤذن إصبعه في أذنيه، لأن حديث بلال اشتمل على ذلك، واستحسن الشافعي أن يترك شئ من نجوم الكتابة، وقال في الشهادة: إذا قالا: نشهد أنه لا وارث له. قال الشافعي: سألتهما عن ذلك، فإن قالا: هو لا نعلم، فذا، وإن قالوا تيقنا قطعاً فقد أخطأوا، لكن لا ترد بذلك شهادتهما، ولكن أردها استحساناً، واستحسن الشافعي تقدير نفقة الخادم، وقال في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت فالقياس أن تقطع يمناه، والاستحسان أن لا تقطع، وقال في الشفعة: استحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام، وقال في المتعة استحسن أن تكون ثلاثين درهما وأما أقوال أصحابه في الاستحسان فكثيرة.
ومن هذا كله يظهر أن المذاهب والأئمة قالوا بالاستحسان، ولا يمكن أن يقولوا به، وينكروه، أو يشنعوا عليه – كما نسب للشافعي ذلك – والحق أن الاستحسان المختلف فيه متفق على منعه، وأن المقبول منه متفق على جوازه، ولذا قال السعد ” وقد أنكر بعض الناس العمل بالاستحسان جهلاً منهم، فإن أنكروا هذه التسمية فلا مشاحة في الاصطلاحات، وإن أنكروا من حيث المعنى فباطل أيضاً، لأنا نعني به دليلاً من الأدلة المتفق عليها يقع في مقابلة القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى من القياس الجلي فلا معنى لإنكاره ” وقال الجصاص: ” استعمل جميع الفقهاء لفظ الاستحسان فسقط بما قلنا المنازعة في إطلاق الاسم، أو منعه، وإن نازعنا في المعنى فإنما لم يسلم خصمنا تسليم المعنى لنا بغير دلالة، بل تضمن لجميع المعاني التي يذكرها مما يتضمنه لفظ الاستحسان عند أصحابنا، إقامة الدليل على صحته، وإثباته بحجة وبيان وجهة “.
وقال الشوكان: قال جماعة من المحققين: الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسيره أموراً لا تصلح للخلاف، لأن بعضها مقبول اتفاقاً، وبعضها متردد بين ماهو مقبول اتفاقاً وما هو مردود اتفاقاً.
وقال الدبوسي: سمو الاستحسان بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس أو الوقف عن العمل به بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله، وإن كان أخفى منه إدراكاً ولم يكن غرضهم من هذه التسمية إلا ليميزوا بين الحكم الأصلي الذي يدل عليه القياس الظاهر وبين الحكم المماثل عن ذلك السنن الظاهر بدليل أوجب الإمالة، فسموا الذي يبقى على الأصل قياساً، والذي يمال استحساناً.
وقال البزدوي: إعلم أن المخالفين لم ينكروا على أبي حنيفة الاستحسان بالأثر والإجماع والضرورة، لأن ترك القياس بهذه الدلائل مستحسن أي الاستحسان الذي وقع التنازع فيه عندنا أي عند أصحابنا أحد القياسين، لا أن يكون قسماً آخر اخترعوه بالتشهي من غير دليل، ولاشك أن القياسين إذا تعارضا في حادثة وجب ترجيح أحد القياسين ليعمل به إذا أمكن، لكنه سُمي أحد القياسين بالاستحسان إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به لترجحه على الآخر، وقال السرخسي: علماؤنا استعملوا عبارة القياس والاستحسان للتمييز بين الدليلين المتعارضين، وخصصوا أحدهما بالاستحسان لكون العمل به مستحسناً، ولكونه مائلاً عن سنن القياس الظاهر فسموه بهذا الاسم لوجود معنى الاسم فيه، بمنزلة الصلاة فإنها اسم للدعاء، ثم اطلقت على العبادة لما فيها من الدعاء عادة.
وأما ما اشتهر عن قول الشافعي: ” من استحسن فقد شرَّع ” فهذه العبارة كما قال السبكي: ” أنا لم أجد إلى الآن هذا في كلامه نصاً، لكن وجدت في الأم أن من قال بالاستحسان فقد قال قولاً عظيماً، ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعها في أن يتبع رأيه ” وكذا لم يرد في الرسالة للشافعي هذه العبارة، ولكن ورد فيها قوله: ” الاستحسان تلذذ ” وينبغي حمل المعنى المراد على غير ما يتبادر منه، جمعاً بين قول الشافعي بالاستحسان والأخذ به في بعض المسائل وبين العبارة المنسوبة إليه ” من استحسن فقد شرَّع ” فتحمل هذه العبارة على الاستحسان المذموم الذي هو إتباع للهوى والتشهي والتلذذ، وهذا غير الاستحسان المبني على دليله كما قال به الحنفية وغيرهم. قال السرخسي: عبارة الشافعي محمولة على الاستحسان بغير دليل، فكثيراً ما يقول الشافعي: استحب ذلك وأي فرق بين هذا، وبين من يقول: استحسن كذا، بل الاستحسان أفصح اللغتين، وأقرب إلى موافقة عبارة الشرع في هذا المراد وفي حاشية العطار قال: إن مراد الشافعي من قوله – فقـد شرع – اثبات الحكم بالتشهي من غير دليل شرعي وبمثل هذا الحمل، قال ابن ملك وابن الحاجب والآمدي وغيرهم، حتى قال ابن الحاجب: أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، والقائلين بالاستحسان يريدون ما هو أحد الأدلة الأربعة، والقائلين بأنه من استحسن فقد شرَّع يريدون أن من أثبت حكماً بأنه مستحسن من غير دليل عن الشارع فهو الشارع لذلك الحكم حيث لم يأخذه من الشارع. وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة. وقال القاضي يعقوب من الحنابلة: ” الاستحسان مذهب أحمد وهو أن يترك حكماً إلى حكم هو أولى منه، وهذا مما لا ينكر، وإن اختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى. ()
 الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أ.د. عجيل جاسم النشمي